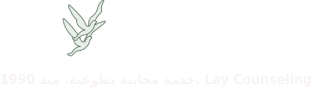أفكار ومقتطفات لأهم الكتّاب
أيوب.. وخيبة الأمل بالله (3)
هل الله ظالم؟ هل الله صامت ؟ هل الله مختبئ؟
بعد وصف قصة أيوب للمأساة والبلية، وقرع الصدر والنقاش الحامي، ورهانٍ كوني يخسر ويكسب، بعد ذلك كله، تنتهي القصة بجو عائلي حميم للغاية، حيث يُسلي أيوب حفدة أحفاده في صفاء تام. ويُورد السفر تعداداً دقيقاً لثروة أيوب المُستعادة: 14000 خروف، 6000 جمل، 1000 فدان بقر، 1000 أتان، فضلاً عن عشرة أولاد.
يشير بعض القراء إلى الختامات السعيدة بوصفها الجواب النهائي عن خيبة الأمل بالله. فيقولون: انظروا! إن الله يُخلص شعبه من الشدة. فقد رد لأيوب صحته وثروته، هو سيفعل لنا الأمر عينه إن تعلمنا أن نثق به على غرار أيوب. غير أن هؤلاء القراء يغضون النظر عن نقطة تفصيلية مهمة: أن أيوب نطق بكلماته الدالة على التوبة والندم قبل استرداد خسائره. وكان ما يزال جالساً وسط كومة تراب، عارياً، تُغطيه القروح... وفي تلك الظروف تعلم أن يحمد الله ويُسبحه. ولكن شيئاً واحداً فقط كان قد تغير: لقد آتى الله أيوب لمحة على الصورة الكبيرة.
لديّ إحساس باطني أنه كان يمكن أن يقول الله أي شيء – كان يمكن في الواقع أن يقرأ من دليل التليفونات – فيحدث لدى أيوب التأثير العجيب عينه. فإن ما قاله لم يكن على التقريب مهما أهمية حقيقية ظهوره المجردة. إذ إن الله أجاب عن سؤال أيوب الأكبر: هل من أحد موجودُ هناك؟ وما إن التقط بصر أيوب لمحةً على العالم غير المنظور، حتى تلاشت جميع أسئلته الملحة.
فمن وجهة نظر الله، لم يكن فرج أيوب – مهما بدا الأمر قاسياً – ذا أهمية مقارنةً بالقضايا الكونية الموضوعة على المحك. وقد انتهت المعركة الحقيقية لما أبى أيوب أن ييأس من رؤية الله، جاعلاً بذلك الشيطان يخسر الرهان. وبعد ذلك الانتصار المبين، بادر الله إلى إغداق عطاياه على أيوب، وكأن الله يقول: "الألم؟ يمكنني أن أتولى أمره بيسر. مزيداً من الأولاد جمالاً وثيراناً؟ لا مشكلة طبعاً، أريد لك أن تكون سعيداً وميسوراً ومفعماً بالحياة. ولكن، يا أيوب، عليك أن تفهم أن شيئاً أهم بكثير من السعادة كان على المحك هنا."
عالَمان
لدي صديقي رشيد (كان قد تحدث عن أزمته وخيبة أمله في بداية الكتاب) وهو مازال ينظر إلى سفر أيوب بوصفه أصدق جزءٍ في الكتاب المقدس – ردة فعل أخرى بعد على خاتمته – فهو يجدها غير وثيقة الصلة بالموضوع إلى حد بعيد، فيقول: "لقد حظى أيوب بظهور شخصي من قِبَل الله، وأنا أغبطه. وذلك هو ما برحت أطلبه طوال هذه السنين. ولكن بما أن الله لم يزرني، فكيف يُساعدني أيوب في صراعاتي؟"
اعتقد أن رشيد وضع إصبعه على خط فاصل مهم في الإيمان. فبمعنى ما، تُشبه أيامنا على الأرض أيام أيوب قبل أن وافاه الله في عاصفة. إذ أننا نحن أيضاً نعيش في خضم معلومات وشائعات، يُحاج بعضها ضد إله قوي محب. وعلينا نحن أيضاً أن نمارس الإيمان، إنما بغير يقين.
انبطح رشيد على الأرضية الخشبية في شقته، مُتضرعاً إلى الله أن "يُعلن" ذاته، راهناً كل إيمانه باستعداد الله لولوج (دخول) العالم المنظور كما فعل بالنسبة إلى أيوب. وقد خسر رشيد ذلك الرهان. وبصراحة، أشك في أن الله يشعر بأي "التزام" لإثبات ذاته بطريقةٍ كهذه. لقد فعل ذلك مراراً كثيرة في العهد القديم، ثم فعله بصورة نهائية حاسمة في شخص يسوع المسيح. فأية تجسدات أخرى نطلب منه؟
إني أقول ما أقوله بعناية بالغة، إذ أتساءل بشأن الرغبة الملحة الشديدة في حصول معجزة – حتى لو كانت شفاء للجسد – ألا تنم أحياناً عن الافتقار إلى الإيمان وليس عن توافره؟ فإن صلوات من هذا النوع، كصلوات رشيد، قد تضع شروطاً أمام الله. وحين نتوق إلى حل معجزي لمشكلة ما، هل نجعل ولاءنا لله متوقفاً على كونه يعلن ذاته مرة أخرى بعدُ في العالم المنظور؟
وإن أصررنا على براهين منظورة من لدن الله، فلعلنا نُمهد السبيل فعلاً لحالة خيبةٍ دائمة. فالإيمان الحقيقي لا يحاول أن يستميل الله كي يفعل مشيئتنا بقدر ما يسعى إلى وضعنا في موضعٍ يحملنا نحن على فعل مشيئته. وإذ فتشت في الكتاب المقدس كله عن نماذج للإيمان العظيم، صعقني العدد القليل من القديسين الذين اختبروا مثل مواجهة أيوب الدراماتيكية مع الله. فالباقون تجاوبوا مع احتجابية الله، لا بمطالبته بأن يُظهر ذاته، بل بالمضي قدماً والإيمان به رغم بقائه مُحتجباً. ويشير الإصحاح الحادي عشر من رسالة العبرانيين بوضوح إلى أن عمالقة الإيمان "لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها"..
فنحن الكائنات البشرية، بطريقة غريزية، نعد العالم المنظور "حقيقياً" والعالم غير المنظور "غير حقيقي". ولكن الكتاب المقدس يدعونا إلى العكس تماماً، فبالإيمان، يتخذ العالم غير المنظور، على نحوٍ تصاعدي، شكله بوصفه العالم الحقيقي ويبسط أمامنا السبيل لكيفية العيش في العالم المنظور. أما عنى الرب يسوع: "عيشوا لله الذي لا يُرى، وليس للآخرين!" في كلامه عن العالم غير المنظور، أو "ملكوت السماوات"؟
وقد تطرق بولس الرسول مرة على نحو مباشر إلى مسألة خيبة الأمل بالله. فقد قال لمؤمني كورنثوس إنه لم ييأس على الرغم من المصاعب والمصائب التي لا تصدق: "وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوماً فيوماً، لأن خفة ضيقتنا الوقتية (!) تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى، بل التي لا تُرى، لأن التي تُرى وقتية، وأما التي لا تُرى فأبدية."
عربون من المستقبل
احتمل بولس التجارب ومات شهيداً، وهو مازال ينتظر مكافأته. واحتمل أيوب التجارب، إلا أنه نال مكافأة حسنة في أثناء حياته. فماذا يمكننا إذاً أن ننتظر من عند الله تحديداً؟ ربما كانت أفضل طريقة للنظر إلى الخاتمة في سفر أيوب أن نراها لا كمخطط لما سيحدث لنا في هذه الحياة، بل بالحري كعلامة لما سيأتي. فهي تقوم رمزاً وافياً وعذباً: حلاً لخيبة رجل واحد يُذيقنا بلغة سبقية من المستقبل.
ومن ناحية، فإن إيلي فايزل على حق وهو يقول: أن مسرات أيوب في شيخوخته لم تُعوضه عن الخسائر التي تكبدها سابقاً. حتى إنه هو نفسه مات أخيراً وهو شيخ سعيد وشبعان أياماً. مُمرراً دورة الحزن إلى أهله الباقين على قيد الحياة بعده. وأسوأ غلطة على الإطلاق أن نستنتج أن الله يقنع، على نحوٍ ما، بأن يُجرى بعض الإصلاحات الثانوية القليلة لهذا العالم المأساوي الجائر.
يرهن بعض الناس إيمانهم كله بحصول معجزة، كما لو أن من شأن المعجزة أن تُقصي كل خيبة أمل بالله. غير أنها لن تفعل ذاك. ولو ملأت هذا الكتاب بملفات الشفاءات الجسدية ، بدلاً من قصص رشيد ومغ ودسن ودوغلاس (كان قد حكى عن أزماتهم سابقاً) وأيوب، ما كان ذلك يحل مشكلة خيبة الأمل بالله. فما زال هذا الكوكب مُبتلى بخطبٍ جلل. ذلك أننا جميعاً نموت، معدل الوفيات الجوهري هو هو للملحدين وللقديسين على السواء.
إن المعجزات تقوم مقام اللافتات التي تُشير إلى المستقبل. أو هي مُشهيات تبعث توقاً إلى المزيد، إلى ما هو ثابت ودائم. ولم تكن سعادة أيوب في شيخوخته إلا عينة مما سيتمتع به بعد الموت. فالأخبار الطيبة في ختام سفر أيوب وبشائر القيامة في أواخر الأناجيل هي عروض مُسبقة للأخبار الرائعة الموصوفة في آخر سفر الرؤيا. ولا نجرؤ أن نُشيح أبصارنا عن العالم الذي يريده الله.
فالوعد الذي يتضمنه أيوب 42 إذا هو أن الله سيرفع أخيراً كل جور (ظلم) تتسم به أيامنا. ومن الأحزان ما لن يُشفى أبداً في هذه الحياة، كموت أولاد أيوب مثلاً، ولكن في نهاية الزمان سيتلاشى ذلك الحزن أيضاً.
إن الكتاب المقدس يرهن سمعة الله بقدرته على دحر الشر ورد السماء والأرض إلى حالتهما الأصلية الكاملة. فبمعزلٍ عن تلك الحالة المستقبلية، قد يُحكم على الله بأنه أقل من أن يكون قديراً، أو أقل من أن يكون محباً. وحتى الآن لم تتحقق رؤى الأنبياء بشأن السلام والعدالة. والموت، مع طفرات السيدا (الأيدز) وسرطنات البيئة، تلك الطفرات الجديدة الشنيعة، مازال يبتلع الناس، بدل أن يُبتلع هو. ويبدو أن الشر، لا الخير، هو الفائز. غير أن الكتاب المقدس يدعونا لأن نتخطى بأبصارنا واقع التاريخ الكئيب لنرى منظر الأبدية كلها، حين يملأ مُلك الله الأرض نوراً وحقاً.
ففي أي بحثٍ بشأن الخيبة بالله، تُشكل السماء الكلمة النهائية، بل أهم كلمة على الإطلاق. ذلك أن السماء وحدها سوف تحل أخيراً مشكلة احتجاب الله. فأول مرة منذ البدء سوف يتاح للكائنات البشرية النظر إلى الله وجهاً لوجه. وقد أوتي أيوب، في خضم معاناته، وبطريقةٍ ما، إيماناً جعله يؤمن بهذا: "بدون جسدي أرى الله، الذي أراه أنا لنفسي، وعيناي تنظران، وليس آخر". وسوف تتم هذه النبوءة ليس بالنسبة إلى أيوب وحده، بل أيضاً بالنسبة إلينا جميعاً.
فيليب يانسي
من كتاب "عندما لا تمطر السماء"
قل رأيك بصراحة
تعرضت للحرمان العاطفي كطفل تحت سن 15 عام
Total votes: 1664
خواطر وأفكار جديدة
اعتناق الضعف؛ جرأة عظيمة
جرأة شديدة.. جرأة عظيمة
خرافة رقم 1، "إن الضعف عجزٌ، الضعف نقصٌ". هذه هي الخرافة والمسلّمة الأكثر شيوعًا والأكثر خطورة كذلك.
إقرأ المزيد...